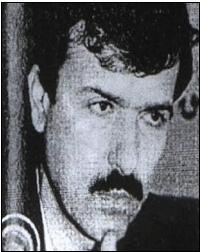فاضل رسول
سعود المولى الشاهد والشهيد كان أولنا وأسبقنا في كل شيء... بعد نكسة حزيران 67 وكان يومها في العراق ومنتمياً الى الحزب الشيوعي العراقي كان فاض...
"نمارقُ جداريةٌ غُفْلٌ اسمها" للشاعرة الأمريكية ماريان بوروش "لا شيء تقريبًا" لعبد اللطيف اللعبي سعود المولى
الشاهد والشهيد كان أولنا وأسبقنا في كل شيء... بعد نكسة حزيران 67 وكان يومها في العراق ومنتمياً الى الحزب الشيوعي العراقي كان فاضل من الذين شاركوا في نقد التجربة المريرة وفي بلورة طروحات التحول اليساري في الحزب ومنها إطلاق الكفاح المسلح بقيادة خالد زكي في الأهوار، وتاسيس مجموعة وحدة القاعدة، ومجموعة الحزب الشيوعي العراقي-القيادة المركزية.
كان سلاح النقد الثوري الجذري هو زاده الأول في تمّيزه بين اقرانه ، وهو سلاح ماركسي أساسي ولكننا امتطيناه على صهوة ربيع طلاب أوروبا الغربية في أيار 1968، وربيع براغ التي دمرتها الدبابات الروسية في آب 1968، الى ربيع الثورة الفيتنامية (هجوم الربيع 1968) ، فربيع الثورة الثقافية الصينية... وقد أسهم فاضل وعادل عبد المهدي ورفاقهما آنذاك في استثارة الحوارات والنقاشات داخل يسار الأحزاب في البلاد العربية كلها، وأثمر انشقاق عشرات الشباب المتمركس.. كما كان لهما دور كبير في النقاش الماركسي في الوسط الطلابي حيث أنه ساعدنا على بلورة صيغة نضال مشترك تجمع قوى اليسار الجديد غير المتشكل بعد في إطار تنظيمي محدد..
الا ان الأهم في ذلك الوقت أن فاضل حمل مبكراً مقاربة مبدعة تمثلت في فهمه الماركسي الجديد للمسألة الدينية في بلادنا. وبرغم أنه لم يكن قد قرأ غرامشي يومها (على ما يبدو) إلا أنه استطاع مبكراً أن يقدم قراءة جديدة نراها تتكرر وتتطور لاحقاً في فهمه للشرق وللاسلام، ثم في فهمه للمسألة اليهودية وللصهيونية وحاضنتهما الحضارية والثقافية وقد التحق فاضل منذ مطلع السبعينيات مع العشرات من رفاقه بالتجربة الفلسطينية في لبنان.
لم يكن عفيف ليكتب أو ينطق علماً الا ليعمل به ويطبقه على نفسه وفي حياته أولاً... وفي بحثه عن الحقيقة لا يخجل فاضل من تقديم نص جديد فيه تقويم عميق وسياسي وسوسيولوجي لفكر وممارسة سابقة، ينطلق من موقف فلسفي وفكري جديد نجده مبثوثاً بقوة في ثنايا رأيه، ومن نقد ذاتي جذري لمسلماتنا "وأساطيرنا" المؤسِّسَة حول المسألة الطائفية والطوائفوالعشيرة والعشائرية والإثنيات والقوميات في الواقع العربي... في العام 75 كان اليسار الجديد قد توزع اتجاهات عدة ما بين ملتحق بالثورة الفلسطينية أو مشارك معها، وما بين ملتحق بالخط السوفياتي التحريفي الدولي، أو بالتيارات اليسارية الثورية العالمية (ماوية- تروتسكية- فوضوية- مجالسية)... أما نحن فكنا نخوض تجربة مميزة من داخل العلاقة المتوترة بين 3 مكونات رئيسة: المكون الشعبي الجماهيري الإسلامي والعشائري والقومي، والمكون اليساري العلماني حامل تراث الماوية، والمكون الجماهيري المتمثل بحركة فتح وحرب التحرير الشعبية... فقد قادتنا ماويتنا الى الارتباط مبكراً بالإمامين موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين من جهة، وتمتين العلاقة مع الشهيدين الكبيرين كمال جنبلاط وأبو جهاد خليل الوزير من جهة ثانية... وهكذا بدأنا نقاشات مطولة حول الماركسية والدين، والاشتراكية والإنسان، والعروبة والوطنية المحلية، والوحدة العربية وحقوق الأقليات غير العربية وغير المسلمة...إلخ، انطلاقاً من كتابات كمال جنبلاط وعلي شريعتي ومالك بن نبي وروجيه غارودي ومن محاوراتنا مع موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين.. وكان فاضل أبرز من اشتغلوا خلال تلك السنوات 1975-1977 على اكتشاف العلاقة ما بين هذه الثنائيات، وذلك على قاعدة ثقافته المتعددة الهويات من عربية وفارسية وتركية وعلاقاته الجدولية الواسعة خارج لبنان واكتشافه لأولوية ومحورية الانسان، حياته، وحريته، وكرامته، وحقوقه، قبل أي شيء وفوق كل شيء...
وقد صاغ فاضل فهمه الفلسفي الجديد بقوله إن الانسان هو الغاية، والحزب هو هيئة معنوية توحد غايتها مع غايات التحقق المعنوي للانسان ... وهنا اكتشف فاضل أهمية الثقافات الإسلامية والقومية المحلية في بلورة اشتراكية إنسانية، ناقداً بقوة لا إنسانية الماركسية وقد تكشفت وانهار اندهاشنا بها منذ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية... أعاد فاضل اكتشاف العلاقات العربية الإيرانية والعربية الكردية والإيرانية الكردية... في السياسة والاقتصاد، في الفلسفة والدين، في التصوف والأخلاق، فأعاد اكتشاف ذاته وهدفه في هذه الحياة...
ومن ثىائية المثال الماركسي أو الإسلامي أو العروبي والواقع المتعدد المتفجر المتكسر، عالج فاضل عدة تنائيات تشطر وعينا الوطني وفكرنا السياسي : ثنائية العنف الثوري التغييري والسلم الأهلي المحافظ، ثنائية الطائفية السياسية واللاوعي الطائفي ، ثنائية التنافي والتدمير المتبادل في صيغة الكيانات العربية ، ثنائية العلمانية والاسلام (وهنا ابتدأ أو عاد اهتمام فاضل بدراسة الاسلام الحضاري والثقافي والسياسي) ثنائية الوطنية أو القومية المحلية والعروبة.. ومن خلال غوصه في عمق فكر وممارسة الماركسيين الماويين العرب أطل عفاضل على القضايا التي ستشكل مفاتيح وعيه ونقده اللاحق للفكر السائد.. فقد عالج مسألة القومية بفهم إنساني جديد وقارن بين فهمنا السابق وبين كلام فرانز فانون عن تخلف بورجوازية العالم الثالث دوراً وفكراً وامكانات... وهو في تلك المرحلة المبكرة كان يناقش المفكر الفلسطيني منير شفيق المسيحي الماركسي الماوي (المتحول لاحقاً الى الاسلام) الذي كان يومها يحاول بلورة أطروحة ماركسية قومية عربية جديدة لقيت رواجاً في أوساطنا التقى مع تيار سوري ماوي تمثل بالحزب الشيوعي العربي ومؤسسه المرحوم هلال رسلان...
في تلك المرحلة 1975-1977 كنا نخوض جدالات ونقاشات وحوارات واسعة وعميقة حول حركة التحرر الوطني العربية، وحول النموذج الفيتنامي والكمبودي في حرب الشعب القومية بقيادة ماركسية، وحول الوحدة العربية والتجزئة الاستعمارية والتخلف ومركزية القضية الفلسطينية في حركة التحرر الوطني العربية ، وحول الماركسيات السوفياتية والصينية في بناء الاشتراكية... وحول تجارب كوبا وفيتنام وكمبوديا وحركات المقاومة في فلسطين وافريقيا الخ..وانضاف الى نقاشاتنا التاريخية تلك حضور الاسلام الثقافي والسياسي... وكانت المناقشات تدور حول اشكاليتين: الاولى هي الهوية الحضارية الخاصة وهل تشكل قاعدة لصياغة وبلورة نظريات ثورية وفكر سياسي خاص مستقل عن الماركسيات التقليدية التي كنا نتبناها؟. وفي هذا الاطار كانت الماوية قد شكلت لفترة ما منقذاً لنا سرعان ما انهار في أعوام 76-77 بعد وفاة ماوتسي تونغ ونشوب الصراع على السلطة في الصين ، ثم اندلاع الحروب بين فيتنام وكمبوديا، وبين الصين وفيتنام ... فكان بحثنا عن أدوات وأطر نظرية جديدة على قاعدة التجربة الفلسطينية من جهة، وصعود التجربة الإيرانية من جهة ثانية، هو ما ميّز فكرنا وممارستنا.
والاشكالية الثانية تعلقت بمسألة النهضة ، والوعي الحضاري، وبناء الذات الحضارية، والاستقلال السياسي والاقتصادي، ومواجهة الآخر.. وكنا قد بدأنا نقرأ مالك بن نبي وفرانز فانون وعلي شريعتي وأنور عبد الملك ونتفاعل مع موسى الصدر وأحمد بن بللا، ونعيد النظر في الأطروحات الماركسية اللينينية، التروتسكية والماوية والفيتنامية على حد سواء، باتجاه البحث عن ماركسية عربية جديدة.. وهنا أيضاً كان منير شفيق مفيداً لنا الى جانب أنور عبد الملك في اكتشاف رؤية حضارية بديلة لا تكون مقلدة للغرب ولا تكون خاضعة للشيوعية المادية، وانما تنبني على تراثات حضارات الشرق الغنية، كالصين والهند والاسلام..
في تلك السنوات المفصلية كانت الصين وروسيا وفيتنام وكمبوديا وكوبا ( وكل الدول الاشتراكية) قد تحولت بالنسبة الينا الى دول قمعية سلطوية استبدادية يموت فيها الانسان ويذبل فيها الضمير الحر والوجدان... لا بل أننا كنا نتبنى التسمية الماوية للاتحاد السوفياتي على أنه "امبريالية اشتراكية" وليس فقط مجرد "تحريفية"... وحين انطلقت ثورة ايران الاسلامية (آخر عام 77- مطلع عام 78) كنا نعيش جدالات وحوارات ونقاشات أفضت بالكثيرين منا الى الالتحاق بالإسلام الصاعد يومذاك كتعبير عن حالة حضارية نهضوية مقاومة وممانعة..
ويمكن القول هنا ان كتابات أنور عبد الملك ومنير شفيق ومحجوب عمر ومحمد عمارة وعادل حسين وطارق البشري وعادل عبد المهدي وفاضل رسول وحسن حنفي وأحمد عباس صالح (وهم من الماركسيين اللينينيين والماويين الذين انتقلوا الى أرض الاسلام انطلاقاً من مقولة تأسيس يسار اسلامي أو وجود يسار في الاسلام)، ثم كتاب ادوارد سعيد (الاستشراق) قد لعبت الدور الأهم في تحديد سياقات وأطر التحولات التي عصفت بجيلنا وجيل فاضل اليساري المناضل..
تلازم صعود الثورة الاسلامية الايرانية وعودة الاسلام السياسي الى ساحة الفعل العربي، مع تصاعد حدة الصراع العربي الاسرائيلي، وتصاعد حدة الأحادية الثقافية الامبريالية الغربية في شيطنتها للآخر، المسلم أو الشرقي، مع تصاعد الأزمة العميقة التي ضربت الماركسية وأقعدتها عن أن تكون أداة نظرية لفهم الواقع وممارسة التغيير ، وذلك قبل سقوطها الأخير مع سقوط الاتحاد السوفياتي وكل المنظومة الاشتراكية... في تلك الفترة كنت من بين الذين أعادوا اكتشاف الأمير شكيب أرسلان، ومن خلاله كل فكر النهضة الاسلامية وخصوصاً محمد عبده وجمال الدين الافغاني ورفاعة رافع الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي.. وشهدت تلك الفترة كتابات لوجيه كوثراني (الاتجاهات السياسية الاجتماعية في جبل لبنان) وسهيل القش (في البدء كانت الممانعة) ومنير شفيق (الاسلام في معركة الحضارة) وادوارد سعيد ( الاستشراق، و: تغطية الاسلام) وحسن الضيقة ( في نقد الماركسية ، ونقد سمير أمين) ونظير جاهل (في أنتروبولوجيا الاسلام) ورضوان السيد (في الجماعة والسلطة والأمة) والياس خوري وحازم صاغية ووليد نويهض (في نقد التجارب اليسارية، وفي مسألة المثقف والسلطة، ومسألة الدولة والحزب الخ..).. وقد صدرت مجلة الوحدة (1980-1981) تحمل هذه الكتابات وغيرها. فتحت مجلة الوحدة نقاشات وجدالات كان لها أثر كبير في فكر ووعي فاضل كما يظهر من استعادتها في مجلة الحوار (باريس وفيينا) ثم منبر الحوار (بيروت). لكن المهم في مقاربة فاضل لهذه الإشكاليات هو إطلالاته النقدية التي تربط ماضي هذا الفكر الاسلامي التجديدي بحاضره.
تلك هي الأطر والسياقات التي واكبت اشتغال فاضل واشتغالنا جميعًا ظاهرة (النظرة الغربية الاستعمارية الانتقاصية للشرق) ، وهي ظاهرة جرى لفت الانتباه اليها مع كتابات المفكرين المشار اليهم سابقاً والذين قدموا قراءة ثنوية عن الصراع بين الشرق والغرب: من ادوارد سعيد وأنور عبد الملك ومنير شفيق (وحتى أدونيس الذي كتب أن انقسام العالم الى قطبين شرق/غرب هو حقيقة قائمة وأن الغرب تميّز بالتكنولوجيا وليس بالابداع، وأن الشرق ابداعي خيالي، الخ.).. هؤلاء المفكرين اندفعوا يومها في تبني الخيار الحضاري الاسلامي فاعترفوا فعلياً بالثنائية العرقية القومية وأقروا بها... وقد تماهينا كلنا يومها (أي هذا الجيل من المثقفين اليساريين العرب المنفتحين على الاسلام الحضاري والسياسي) مع فرانز فانون من حيث الكلام عن (ردة فعل) وعن انقسام العالم الى جنسين مختلفين (أبيض مستوطن وأسمر ملون) يقطنان في مدينتين مختلفتين ... إلخ. ويجب الاعتراف هنا لهؤلاء المفكرين ومنهم فاضل بالفضل في أمور كثيرة خصوصاً لدورهم في إغناء عملية الانبعاث الاسلامي الجديد بمعطيات تنويرية هائلة.. وعلى الرغم من كون هذه الحركة الاستشراقية المعكوسة متطرفة في عدائها للغرب إلا أنها "تبقى في المحصلة النهائية ردة فعل مناهضة للغزو البورحوازي الغريب لبلاد وعقول المسلمين (كما كتب عفيف فراج يومها)... لقد ابتدأنا بنقد المثقفين الماركسيين العرب لتغربهم عن الثقافة الوطنية وعجزهم عن الانخراط مع الجماهير العريضة واغترابهم الاجتماعي الثقافي وعجزهم عن انجاز أيديولوجية ثورية تتلاءم مع العصر دون القطع مع الماضي، أي دون التضحية بالاستمراية الثقافية التاريخية... وكنا نستهعير مقولة غالي شكري: "يجب أن نهدم ثم نعيد بناء تراثنا الثقافي من منظور ثوري مقتبسين من تراثنا ومن الغرب ما يتناسب وحاجتنا الموضوعية" وهي استمرار لمقولة التنويريين الأفغاني ومحمد عبده... واشتغلنا جميعناعلى مقولة استنباط وصياغة حداتثنا الخاصة بنا وعلمانيتنا النابعة من سياقاتنا التاريخية والحضارية الخاصة، وفلسفة أو ايديولوجية جديدة لنهضتنا المعوقة والناقصة... تستعيد تراثنا الحضاري ولا تموت غرقاً فيه، وتأخذ من الحضارة الغربية ولا تكون تابعة ذيلية لها..إنها اليوم (وكما كانت بالأمس) أكثر من قضية ملحة.. إنها هي القضية!
حاول فاضل وحاولنا في مرحلة أولى الدفاع عن بعض المواقف الماركسية اللينينية الماوية تجاه الشرق وتمييزها عن المنحى الانتقاصي والاحتقاري للغرب البورجوازي، وكان ذلك آخر سهام محاولة الجمع بين الاسلام والماركسية، وهي المحاولة التي عشنا تجربتها معاً خلال تلك المرحلة (1977-1980) قبل أن تطغى علينا فكرة المفاصلة الكاملة مع الغرب بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، والتي كانت على ما يبدو من منبع ماوي صيني وليس من منبع إسلامي تقليدي.. ذلك أن الاسلاميين من جيل محمد عبده والافغاني والطهطاوي وشكيب أرسلان، ثم من جيل عباس العقاد ومصطفى صادق الرافعي وطه حسين، كانوا قد حاولوا الجمع والتأليف ما بين شرق وغرب على قاعدة الخصوصية الحضارية السمحة المنفتحة التي تأخذ الحكمة والعلم أنى وجدتهما... غير أن الإشكالية في عصرنا الراهن وفي حاضرنا المعيش هي أعمق وأبعد من ذلك... وفاضل حاول مقاربتها من خلال تقديم قراءة مميّزة عن التدخل الخارجي ودوره في مصائبنا خصوصًا لجهة تصعيد وتوتير الاختلافات الإثنية والدينية والمذهبية.. فاستعاد بذلك موقف الافغاني التاريخي الذي وجد أن الاستبداد هو علة هذا الشرق، دون أن يغرق في التأبيد الذي اصطنعه الغرب والذي جعل من الاستبداد الشرقي جوهراً أزلياً ثابتاً يسم الشرق ، ودون أن يغرق في الاستشراق المعكوس الذي يجعل الاحتقار والانتقاص الغربي جوهراً أزلياً ثابتاً..
كان فاضل رسول يعمل على الحوار بين الأكراد والإيرانيين وبين الأكراد والأتراك وذلك من منطلق ايمانه العميق بضرورة إنهاء الصراع في المنطقة، وعمله مع غيره على بناء مشروع حضاري مشترك. فقد كان يحلُم مثلنا بشرق جديد موحّد، في مشروع حضاري جديد يحتضن العرب والأتراك والإيرانيين والأكراد وكل الآخرين من أبناء وبنات هذا الشرق .
وبما أنه كان كردياً (ولد بالسليمانية عام 1949)، وتربى بثقافة متنوعة كردية، وعربية، وفارسية، فقد بنى جسوراً ثقافية مبكرة بين هذه العوالم الثقافية الحضارية، ساعده في ذلك شخصيته الفذة وروحه الإنسانية وأخلاقه الرفيعة .
بدأ فاضل رحلته الفكرية والسياسية وهو فتىً يافع. فقد انتمى الى الحزب الشيوعي العراقي في مقتبل عمره (13عاما) ثم ترك صفوف الحزب أواخر ستينيات القرن العشرين بعد انهيار حركة الكفاح المسلح بقيادة الشهيد خالد زكي في الأهوار. وأسس مع زملاء آخرين له جماعة (وحدة القاعدة) والحزب الشيوعي-القيادة المركزية (التي كان من بينها الدكتور عادل عبدالهادي ومظفر النواب) . في تلك الأثناء كان فاضل ورفاقه متأثرين بالفكر الماوي معارضين لإمبريالية الاتحاد السوفياتي داعمين للحرب الشعبية طويلة الأمد.
في منتصف السبعينيات لجأ فاضل رسول (وعادل عبد المهدي) إلى أوروبا الغربية، وأقام في النمسا وأكمل دراساته العليا، فحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية بـ (برلين) عن أطروحته بـالالمانية (تدخل القوى العظمى: الاتحاد السوفيتي والقضية الكُردية) ثمّ أصبح أستاذا في إحدى الجامعات في فيينا.
تعرفت عليه وعلى عادل عبد المهدي في بيروت عام 1973 وكانا يحضران من أوروبا (باريس وبرلين وفيينا) للإشراف على عمل حزبهم والتنسيق مع الماويين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين.
انخرط فاضل في الحركة الوطنية الكُردية مبكرا ضمن صفوف الحزب الديموقراطي الكُردستاني.و شارك مع عادل عبد المهدي وجلال طالباني في تأسيس البدايات الأولى للاتحاد الوطني الكُردستاني أواسط السبعينيات من القرن الماضي.
في العام 1977 حدث انقلاب فكري في مسار فاضل رسول ورفاقه الماويين (ومنهم نحن اللبنانيون) حيث طلّقنا التجربة الحزبية اليسارية وانهمكنا كل من موقعه في مراجعة التجربة وبلورة مشروع تغيير جديد يجمع بين اليسارية العلمانية الثورية والإسلامية الحضارية التغييرية. أصدرنا معا نشرة ماوية نظرية باسم (الوعي)(صدر منها ثلاثة أعداد 1977) وجريدة سياسية باسم الكلمة (وحدة الكلمة وكلمة الوحدة) (صدر منها عشرة أعداد 1977) ثم جريدة الوحدة السياسية التحريضية الأسبوعية (وأحيانا صدرت يومية في صفحتين) التي صدرت طوال أعوام 1977-1979 وكانت بإدارة أصدقاء انضموا إلينا من حزب البعث الديمقراطي (جماعة شباط أو صلاح جديد) تلاها مجلة الوحدة (ثقافية فكرية)تصدر كل شهرين 1979-1980) لم تعمر هذه النشاطات طويلا إذ جاءت الثورة الإيرانية لتفتتح زمنا جديدا.
انشغل فاضل مثلنا في النشاط الفكري والثقافي الناجم عن الأفق الجديد للحركات الاحتماعية . فألّف كتباً وترجم أخرى مثل:(تاريخ الحركة الثورية في إيران) ، (النفط والثورة)، (ايران غربة السياسة والثورة) لبني صدر ، (الحد الفاصل بين السياسة والدين) لمهدي بازركان، ولاحقاً كتابه الشهير (هكذا تكلّم علي شريعتي) الذي كان أول تجميع وقراءة نقدية لفكر شريعتي بالعربية.
عاد فاضل يقرأ تاريخ الأكراد والمنطقة عموماً من زاوية أوسع، أي من حيث البنية التكوينية للصياغة التاريخية لمنطقتنا في خلال أربعة عشر قرناً. كانت رؤية فاضل للتعدد الاثني قائمة على انها كانت موجودة منذ القدم وصاغها الاسلام برحابة ويسر، لكنها تتأزم اثناء التدخل الخارجي.
الإسلام، كما يرى فاضل، لم يلغ الهويات المتعددة الاثنية والدينية والمذهبية. ومن هذا الباب طرح فاضل في المجلة التي أسسها بين فيينا وباريس عام 1985 (منبر الحوار) (والتي شاركته في تحريرها من باريس قبل انتقالها إلى بيروت برئاسة الصديق وجيه كوثراني) جملة محاور أساسية لقضايا الشرق تمثلت في ضرورة تكوين الحوار بين الاتجاهات المختلفة، حل القضايا القومية (كالقضية الكُردية) سلمياً، وانهاء الصراعات الداخلية التي كان فاضل يرى انها تدخل المنطقة في دائرة مميتة، وهي بالتالي تجلب الاحتلال الخارجي الذي يسبب الكوارث الكبرى للاجيال.
ومن هذه الزاوية كان يحلل تقسيم كُردستان كمؤامرة خارجية لاستنزاف المنطقة، عبر إدامة الصراع.
عمل فاضل وجاهد من اجل حل القضية الكُردية في الدول التي تقتسمهم، سلمياً، ضمن التوجه العام لوحدة المنطقة حضارياً في وضع شبيه بالاتحاد الاوروبي اليوم.
وعلى الرغم من انه لم يكن يؤمن بالحكم الذاتي كحل نهائي للقضية القومية، لكن فاضلاً اعتبره خطوة جيدة لانتعاش الثقافات المضطَهَدة، والتي رأى فاضل انها روافد غنية تصبّ في الثقافة المشتركة لشعوبنا. لكن فاضل رسول كان قلقاً جداً من قلّة الوعي العام لابناء المنطقة ـــ بمختلف انتماءاتهم ـــ ازاء مخاطر الهيمنة الخارجية، السياسية والثقافية. يعلل فاضل قلّة الوعي هذه بالاستغراق في الصراعات الداخلية الاستنزافية التي تعيش على العصبيات والعنصريات.
في مقال له بمنبر الحوار، بعنوان: حول دور المؤثر الخارجي في تطورالمسألة القومية والطائفية، عدد 11 خريف 1988، يشير فاضل الى مخطط اسرائيلي ــ امريكي لتفتيت المنطقة الى كيانات صغيرة ومتناحرة، ويضرب المثال بالعراق و أن المخطط الخارجي يهدف الى تفكيكه الى ثلاثة كيانات متنازعة: شيعي وسني وآخر كُردي. الامر كذلك بالنسبة الى لبنان وسوريا وتركيا ودول أخرى. ومن هنا فان طرح فاضل بالنسبة الى كُردستان كان نابعاً من قراءة استراتيجية للمنطقة بشكل عام. وعلى هذا الاساس كان يرى استقلال كُردستان وتوحيد الشعب الكُردي، المجزأ، ضرورة حتمية ضمن توحيد المنطقة حضارياً في تنوع منسجم ومتآزر. واعتبر بقاء الوضع الكُردي عالقاً دون حلّ، بوّابة مفتوحة امام القوى العظمى الطامعة في التدخل في المنطقة، واستغلال الصراعات فيها وبالتالي نشوء عوائق كبيرة امامنا للنهوض.
في ما يخص مسألة الدين وقف فاضل ضد التعصب والتطرف الديني، وكان يرى ان الدين بطبعه يرفض التطرف لأنه يخالف فطرة الانسان السليمة، والتي جاء الدين اليها لتربّيها بلطف ويسر. ولعلّ تأليفه كتابا عن علي شريعتي، المفكر الايراني المشهور، جاء لتأصيل مفهوم الحوار والتسامح والانفتاح بين ابناء المنطقة على اختلاف الاديان والمذاهب والقوميات.
وفي الاسلام، وجد فاضل نفسه على هدى الوسطية فيه، جامعاً بين الدنيا والآخرة. ومن هنا كان يرى فاضل ضرورة وجود الحوار بين التيارات الفكرية العلمانية والدينية والقومية في دائرة سمحة وحضارية. ومن هذا الباب يعود فاضل للتذكير بالتدخل الخارجي المخرِّب في منطقتنا بذرائع كثيرة اهمها الصراعات الداخلية. ففي كتاب له باللغة الألمانية عن القوى العظمى وتدخلاتها في الشرق، ضمن الصراع الذي كان قائماً بين الاتحاد السوفيتي السابق والغرب الرأسمالي بقيادة امريكا، يشرح فاضل بالتفصيل مواقع الضعف الشرقي وعوائق النهوض الحضاري. هذه الآلام الفكرية دفعت بفاضل الى الاندفاع الكلّي نحو حوار جدّي وليس ذلك الحوار المنافق الذي يملأ الصحف والشاشات بهوّامات وفراغات. وهكذا فقد رتب فاضل حواراً هاماً وجديّاً بين العلمانيين والاسلاميين والقوميين في مطلع عام 1989 في محاولة بلورة فكرية وعملية، يعتبرها المفكر اللبناني وجيه كوثراني المحاولة التأسيسية الأولى للحوار بين الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة في الشرق. يُشير كوثراني (رئيس تحرير منبر الحوار بعد استشهاد فاضل رسول) ان الحوار الذي كان امنية قريبة من الخيال في الثمانينيات والتسعينيات استطاع فاضل ان يجسده في الواقع رغم صعوبات الظروف. شارك في جلسة القاهرة أحمد كمال أبو المجد، عادل حسين، محمد عمارة، طارق البشري، فهمي هويدي، عصمت سيف الدولة، محمد سليم العوا، علي الدين هلال، سعد الدين ابراهيم وآخرون... وتبناها محمد مهدي شمس الدين وأحمد بن بللا. بعد استشهاد فاضل استمر الشيخ شمس الدين يجمع محاوري القاهرة كل سنة في منزل الصديق الدكتور محمد سليم العوا.
في الواقع لم تكن علاقة فاضل بايران علاقة ودية دائمة، تماما مثل حالنا نحن أيضا في تلك الأيام التي كتب السيد هاني فحص تفاصيلها . فبالرغم من توجه فاضل الاسلامي (المنفتح جداً) الا ان الإيرانيين لم يكونوا ليتعاملوا معه بمحبة ووضوح. فعلي شريعتي الذي كتب عنه فاضل كان ضد التعصب الشيعي وكان معارضاً للصفوية كفكر وكنمط. ناهيك عن صلة فاضل بابو الحسن بني صدر ومهدي بازركان (ورموز حركة تحرير إيران) ثم بالشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي احتضن ودعم مجلة منبر الحوار وبكى حين أخبره علي ولايتي باستشهاد فاضل. كذلك فقد كان فاضل ضد استمرار الحرب مع العراق وكان يدعو الى حقوق القوميات والطوائف داخل ايران. بالاضافة الى عامل مهم في مسار فكر فاضل انه عاد الى الدائرة الاسلامية كفكر وتاريخ قبل الثورة الايرانية باعوام مثلنا نحن وعبر تجربته الثورية الخاصة القائمة على الاستقلالية والمبدئية والاستقامة على الحق والعدل . فلم يحصل فاضل رسول على شئ من الجمهورية الاسلامية، على الرغم من مرور عشرة اعوام، لغاية 1989، على قيامها. الشئ الوحيد الذي تلقّاه رسول من ايران هو الرصاصات التي أنهت حياته.
أعتقد أنه كان هناك صراع (كما يحصل دائما) بين جناحين في السلطة الإيرانية: جناح يريد الحوار والتسوية مع الأكراد (رفسنجاني خصوصًا) وجناح أراد ضرب ذلك كله بعملية تفجر كل شيء (المخابرات والحرس الثوري خصوصًا) ، تمامًا كما حصل في قضية الشيخ منتظري ومهدي هاشمي وإيران غيت في عام 1986
شهدت تلك المرحلة 1986- 1989 تفاقم الصراع بين التيارين على وقع مرض ثم وفاة الخميني، وتصفية كل تيار حسين منتظري وبعده تصفية ما سمي يومها بجماعة خط الإمام (محتشمي، خاتمي، خوئيني هاه، صادق خامنئي، معادي خاه، ورفاقهم) لصالح تيار خامنئي- ولايتي المتحالف والمعتمد على جماعة "الحجتية" في المخابرات ومنهم أحمدي نجاد قائد عملية اغتيال فاضل رسول.